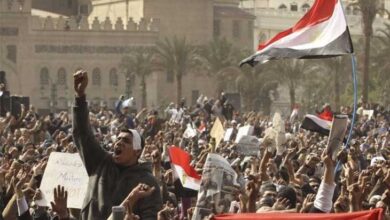عمارة العُزلة.. تدشين أركان الفُوبيا!/ محمد جميل خضر

منذُ كهفِ أهل الكهف، شيّد بنو البشر أركان وجودهم داخل تضاريس المنطقة المختلّة بين توقهم للتنحّي جانبًا واعتزال الآخرين، وبين الغوص في عجاج التواصل وديناميّات التفاعل المزدحم بالحَيوات والاحتمالات وتقاطع السيْرورات وشبكاتِ اشْتراطاتها.
وعلى مدى التاريخ، شكّلت الرغبة في العزلة عنوانًا جوهريًّا من عناوين الوجود. يعتزل الأنبياءُ الآخرينَ لتحقيق أعلى حساسيات التواصل مع وحي النبوّة. يعتزل الشعراء مؤمّلين الإمساك بميكانيزمات عبقر حروفِهم. يعتزل المتوجّسون شرورَ التّعالق مع الآخرين. يعتزل كارهو الضوضاء. يعتزل المهزومون ممّن أقرّوا بخسارتهم جولة الحياة، وقد وصلت مغامرة خوضهم لها بابًا مغلقًا.
وعلى خلاف مقولة أرسطو من أن الإنسان حيوان اجتماعيّ سياسيّ بامتياز، فإن حجارة البيت، وأسوار القلعة، ومساحات المحيط الخاص، وحدود الدول، وجزر الصمت، والأشجار الباسقة، والدروب الضيّقة، كلّها، وغيرها، تعزّزُ، بشكلٍ أو بآخَر، مداميك العزلة، وتوسّع معطيات التباعد.
تصاميمُ العزلة
بقدرِ ما تفرض علينا أسباب العيش أن نحتكّ بغيرنا، ونتفاهم مع شركائنا فيه، ونفهم مستلزماته، ونستجلي موجباته، وتصاريف ديمومته، بقدرِ ما يجترح كثير منّا ابتكارات ضمانِ هذا العيش مساحةً خاصة به، لا يشاركنا فيها أحد، ولا يقتحم خلال استمتاعنا بها ورشْفها عن آخرها متطفّل.
جدليةٌ دفعت بعض مؤْثري أوقات العزلة على ساعات التشارك، إلى توجيه أفكار العمارة الخاصة بهم، نحو الوجهة التي تلبي دافعيتهم تلك، وتتيح لهم تحصنًا متينًا يلوذون به، ويتخنْدقون داخل دهاليزه. إن رهابهم من مسألة، أو دلالة، أو فعل، أو شخص، أو مكان، أو حالة، أو عنصر من عناصر الوجود (الماء والنار والتراب والهواء)، هو الذي يرسم تصميم عمارتهم، ويهندس مساحة ابتعادهم، ويؤثث غرف عزلتهم. ولتبريرِ كثيرٍ من مفردات عمارة العزلة، تلاعبنا بالألفاظ؛ فأصبحت غرفة الاستقبال المعزولة، تمامًا، عن باقي مفردات البيت وغرفه وفضاءاته، ماركة مسجلة، خصوصًا في شرقنا العربيّ المحافظ. وارتحنا لتفسير الأمر أنه مجرّد تحقيقٍ لِخصوصية ضرورية، فلا يعقل أن تكون تفاصيل بيوتنا متاحة جميعها لكل زائر حظي بضيافتنا! وإمعانًا بتصاميم معمارية تعالج (فوبيا) تلصص الآخرين، شيّد كثير منّا بيوتهم بلا نوافذ مفتوحة للجهة المطلّة على شارع، أو المواجهة للساحة الرئيسية في الحيّ. مجرّد جدران صمّاء، أشبه بسجونٍ بِلا أحكام، وقبورٍ بِلا شواهد. على أن العزلة في اللحد مطلقة، وفي الكهف مرحلية، لكنها في البيوت وظيفية، تخدم موجبات حِشْمةٍ مبالغٍ فيها، تكاد تنتسب إلى تشخيص مرضيّ، لا تختلف كثيرًا، بل لعلها لا تختلف بتاتًا، عن النّقاب فوق الوجه على اختلاف أسمائه: الخِمار، الشادور، البشنك، البرقع، البوشيّة والروبند بمحجريْن شبكييْن يسمحان ببعض وظائف العيون.
السجن عمارة عزلة؛ من جهةٍ، نعزل السجين داخله، ومن جهةٍ ثانيةٍ، نعزل خلف أسواره قوانيننا الخاصة بالعقاب والثواب. وكلّما رفعنا جداره الخارجيّ أعلى، كلّما أمعنّا إحاطته بالهيبة والأسرار، وغرسنا الرعب في قلوب المارّة، وقلوب الداخلين إليه والخارجين منه.
قلاع العزلة
“آلموت. إنه حصن فوق صخرة على ارتفاع ستة آلاف قدم، تحيط به جبال جرداء وبحيرات منسيّة، ولهوب وممرات جبلية غير مُفضِية. وليس في مقدور أكثر الجيوش عديدًا الوصول إليه إلا رِجلًا إثر رِجل، ولا أقوى المجانيق ملامسة أسواره. ويبدو حصن آلْموت للقاطنين فيه وكأنه جزيرة وسط محيط من الغيوم، وإذا نُظر إليه من تحت فإنه مأوى الجِنْ” (أمين معلوف، رواية “سمرقند”، فصل: “فردوس الحشاشين”، ص133).
لعلّ العزلة الباطنية التي اختارها حسن الصباح (1037 ـ 1124)م، مؤسس حركة الحشاشين (طائفة إسماعيلية نزارية)، من أكثر عزلات التاريخ العربيّ الإسلاميّ دموية وغرائبية ومفصلية بما أنتجته من فوضى عارمة.
في حصن حصين، مكين بأكثر كثيرٍ مما وصفه معلوف (1949)، في روايته المشار إليها أعلاه. وأبلغ أثرًا مما وصف قلعة الحصن الرحّالة الإيطاليّ ماركو بولو (1254 ـ 1324)م:
“فيها حديقة كبيرة ملأى بأشجار الفاكهة، وفيها قصور وجداول تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء، وبنات جميلات يغنين ويرقصن ويعزفن الموسيقى، حتى يوهم شيخ الجبل أتباعه أن تلك الحديقة هي الجنة، وقد كان ممنوعًا على أيّ فرد أن يدخلها، وكان دخولها مقصورًا فقط على من تقرّر أنهم سينضمون لِجماعة الحشاشين. كان شيخ الجبل يُدخِلهم القلعة في مجموعات، ثم يُشرِبهم مخدّر الحشيش، ثم يتركهم نيامًا، ثم بعد ذلك كان يأمر بأن يُحملوا ويوضعوا في الحديقة، وعندما يستيقظون فإنهم سوف يعتقدون بأنهم قد ذهبوا إلى الجنة، وبعدما يُشبعون شهواتهم من المباهج، كان يتم تخديرهم مرة أخرى، ثم يخرجون من الحدائق ويتم إرسالهم عند شيخ الجبل، فيركعون أمامه، ثم يسألهم من أين أتوا؟ فيردون: “من الجنة”، بعدها يرسلهم الشيخ ليغتالوا الأشخاص المطلوبين؛ ويعدهم أنهم إذا نجحوا في مهماتهم فإنه سوف يُعيدهم إلى الجنة مرة أخرى، وإذا قُتلوا أثناء تأدية مهماتهم فسوف تأتي إليهم ملائكة تأخذهم إلى الجنة”!
في تلك القلعة، فوق جبال ألْبز (أو الديلم) الممتدة من أذربيجان وحتى تركمانستان مرورًا بإيران، تحصّن الصباح ناشدًا عزلةً من نوعٍ غير مسبوقٍ في أيامه؛ عزلةَ القوة، البطش، العمل السريّ، وغسل العقول. في عزلته المرعبة، المسكونة بالجن والترنّح والغواية، أسس (شيخ الجبل)، أوّل فرقٍ منظمةٍ للموت في التاريخ الإسلاميّ (الصباح ليس من أصول عربية، بل هو طهرانيّ المولد، وترعرع تحديدًا في مدينة الريّ، جنوب العاصمة الإيرانية).
فهل هي مفارقة سوداءُ الكوميديا حتى الضحك المغسول بدموع القهر أن تحمل قلعته المنذورة لأبشع أشكال الموت، اسم آلْموت؟
تعرجات حجرية تتلوى مثل أفعى متحفّزة السُّم. لا تشبه عش النسر في شيء، على أن فيها من جُحر الضبع ووِجار الثعلب ووكرِ العسس. وحين تتجلّى المآذن بوصفها نقطةَ التقاء بين الأرض والسماء، فإنها وهي تحيط حصن إدارة الموت، كما تفترض الرسومات المتخيلة للقلعة، مجرّد عيون تلصصٍ تشيعُ الخدرَ قبل الوصول إلى قمّة الجبل. مسروقةٌ كثيرٌ من تفاصيل التصميم المتخيّل لحصنِ آلْموت، من تصميمٍ متخيّلٍ آخر، يخصّ برج بابل، وبين التصميميْن، دَفْعُ الحضارات للحضارات بين دجلة والفرات. بينهما عُزلتان؛ واحدة للتاج، وأخرى لِمقصلة التيجان.
برج العزلة العاجي
“عنقكِ كبرجٍ من عاج. عيناك كالبرك في حشبون عند باب بث ربيم. أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق” (سفر نشيد الأنشاد، الإصحاح السابع، الآية الرابعة). يذهب كثير من المفسّرين أن العروس (شولميت) في نشيد الأنشاد إنما هي الكنيسة، وحين يصلون إلى الآية الرابعة من الإصحاح السابع، يجدون في تشبيه عنقها بالعاج تأكيدًا على مقاربتهم، فالعاج يُنتزع من الفيل بعد موته، وبالتالي فالعروس قد “عاشت حياة الإماتة بعد معموديّتها”. فهل نحن في طريقنا لبحث عمارةٍ قائمةٍ في المتخيّل من وعيٍ دينيٍّ متسلّح بالمقاربات المُفضية إلى دروب السماء؟
ليس الأمر كذلك حين ننقل المقاربة إلى برج المثقفين العاجي. فهو هنا برجٌ متمحْوِرٌ حولَ أفلاكِ العزلة القائمة على الغطرسة. المشيّدة بمركّبات نقصٍ مطعّمٍ بفوقيةٍ جريحة!
برجٌ جدرانه رموز، سقفه أهواء، حوشُه مَجاز، عمدانُه قشور الكتب وادّعاء الاطلاع على مقدمة ابن خلدون.
يختار من يظنّون أنهم بلغوا درجة الإشباع المعرفيّ، عزلةً طوعيةً تريحهم من أشراك الاشتباك مع الآخرين. ولتحصين هذه العزلة بمتاريس شائكة مستحيلة الثغرات، فإنهم يمعنون في التجريد، فإذا بالتفاصيل التقليدية للعمارة الإنسانية تغيب، والأبواب تُوصد، والألوان تكْلحُ جميعُها بالرماديّ الفاقد لأي موقف، العاجز عن أي ثقفٍ للرُّمح، أو توجيهٍ للسَّهم.
مُنمنماتُ العزلة
“يرانا البحر من خلف الحديد الصدئ. ثمّةَ غشاءٌ يقف بيني وبين البحر. أنا الإنسان الشيء الموجودُ الغائبُ عن مدينتي. تأتي غربتي من عزلتي عن مدينتي. شبكٌ حديديٌّ يقف بيني وبين البحر” (ليلى السيد حسين، مجلة “رحلة”).
تغزل الكاتبة في نصّها المعنوَن “عن عمارة العزلة وأتباعها: التشيُّؤ القسريّ”، منمنماتُ عزلتها المحاولة تهجئة اسم مدينةٍ مبتورةَ الأطراف، محطمةَ الميناء، إنها بيروت التي تتحوّل عزلة ليلى السيد حسين فيها إلى غربةٍ “على شكل هلوساتٍ عنيفة”، عالقةٍ في آلة بيعٍ خالية من الدولارات، حيث ينتحل أحدهم شخصية بنّاءٍ ويشرعُ في ردمِ البحر!
عزلةٌ غريبةٌ مطحونةٌ على شكلِ معماريٍّ لا يَشْعرُ ولا يُشْهِرُ وجدَه.
تمعن ليلى في وصف غربتها/ عزلتها، فتقول في نصّها الفريد العميق، مستعرضةً أشكال هذه العزلة من دون فواصل ولا ضوابط ولا علامات ترقيم:
“على شكل بيوتنا التي باتت سجونًا، وعلى شكل السجون التي باتت بيوتًا، وعلى شكل أشكال العمارة الباهتة والطامحة إلى السماء، فلا نطالها ولا تطالنا، وعلى شكل التمدّن المزيّف، وعلى شكل التقليد الأعمى، وعلى شكل الكسارات الآكلة بطونَ الجبال، وعلى شكل الجبال التي تريد أناسَها، وعلى شكل أناسِها الذين لا يريدون إلا أحشاءها، وعلى شكل الأحشاء المهترئة الممتلئة بسموم اللحوم، وعلى شكل أحشاء عماراتنا الممتلئة بالملل الطويل، وعلى شكل الملل من الاغتراب، لأننا ألفناه، وعلى ألفة كل ما هو ليس بمألوف كأنْ يعيش بعضنا فوق بعض في غرف ممتلئة من دون شمس أو نور، وكأنْ نرى سماء المدينة من وراء الأسوار، وكأن نحب شجرة في آخر شارع الحي، وكأن نراها تُقتلع من جذورها فنمشي متلكِّئين خانعين قابلين بالعنف الوارف المخضرّ المتجدد الذي يقتلع كل شجرة ويجلس مكانها. يأتي الاغتراب على شكل الأبنية القائمة، وعلى شكل الأبنية اللاحقة، وعلى شكل بُعدِ البحر والهواء والشمس عنّا وعلى تشيُّئِنا شيئًا فشيئًا، وعلى شكل ترويض العمارة العنيفة للوحوش الكامنة في أجسادنا”.
إلى أن تقول: “يرانا البحر من خلف الحديد الصدئ. لا نطاله ولا يريد هوَ أن يطالنا”.
عزلةُ الكهوف
تقوم سرديات كثيرٍ من الزهّاد على تمجيد العزلة، ولكي يقرنوا القول بالعمل، يصعد البالغون منهم درجة الانصراف الكليّ عن الحياة (الدُنيا)، نحو أعالي الجبال، يسرجون لهم هناك معابدَ قليلة البهرجة المعمارية. أو لعلهم ينتبذون لأنفسهم مكانًا قصيًّا، داخل كهفٍ ربما، أو في مغارة بعيدة عن عيون البشر، مكتظة بكائنات تزحف، أو تطير. على كل حال، لا يبتعد اختيار المعبد فوق الجبل، عن اختيار كهف، فالكهف في تعريفٍ لُغويٍّ مبسَّط هو الثُّقبُ المتّسع في الجبل، وأمّا المغارة فهي الثُّقب الضيّق فيه. لا عمارة مقصودة لذاتها، إذن، لا بهرجة في الشكل والتدوير، ولا أعمدة ولا تيجان ولا مسلات ولا أقواس ولا نِسب ولا مفردات دهشة. مجرّد ثقب. قبر مؤقت حتى بلوغ القبر الدائم.
هناك يتآخى العابد مع جيرانه في الكهف، وقد يضع يده على لغة تخاطب ممكنة بينه وبين خفافيش الكهف وعقاربه وأقاربه فيه. هي لغة الزهد، لا تصعب، عادة، على من يختارها ملاذًا، هروبًا من مقبرة الشهوات خارج الكهف.
ما يميّز الكهف عن العمارة الإنسانية على مدى تاريخها أن الكهف، في معظم تفاصيله، ليس من صنعنا، وبالتالي يقتصر دورنا على صناعة تكيّفنا مع تفاصيله البنائية من طولٍ وعرضٍ وانثناءاتٍ وما إلى ذلك، وعلى صناعة قيمة وظيفية له، منسوجة داخل خطوط وعينا، ومنحنيات الشك والإيمان، اليقين والحيرة، داخل أعماقنا.
جحيم العزلة
في واحدة من أبلغ مداخلات أليكسي (أو إليوشا)، الأخ الثالث في رواية الروسي فيودور دوستويفسكي (1821 ـ 1881) “الأخوة كرامازوف”، يقول الشاب المتديّن المسافر حاجًّا في دروب الإيمان:
“تسألني متى يتحقق ملكوت السماوات على الأرض؟ فاعلم أن ملكوت السماوات سيتحقق على الأرض في أحد الأيام؛ لكن ذلك لن يحدث إلا بعد انتهاء عهد العزلة.. العزلة التي يعيش فيها البشر، وتتجلى في جميع الميادين، ولا سيما في عصرنا هذا. إن عصر العزلة هذا لم ينته؛ حتى إنه لم يصل إلى ذروته. إن كل إنسان في هذا العصر يجهد في سبيل أن يتذوّق الحياة كاملة مبتعدًا عن أقرانه، ساعيًا إلى السعادة الفردية. ولكن هيهات أن تؤدي هذه الجهود إلى تذوّق الحياة كاملة، فهي لا تقود إلّا إلى فناء النفس فناءً كاملًا، ولا تقود إلّا إلى نوعٍ من الانتحار الروحيِّ بعزلةٍ خانقة. لقد انحلّ المجتمع في عصرنا إلى أفراد يعيش كل منهم في جحره كَوحش، ويهرب بعضهم من بعض، ولا يفكّرون إلا في أن يخفوا ثرواتهم عن بعض. وهم يصلون من ذلك إلى أن يكره بعضهم بعضًا، وإلى أن يصبحوا جديرين بالكره هم أيضًا.
إن الإنسان يكدّس الخيرات فوق الخيرات في العزلة، وتسرّه القوة التي يحسب أنه يملكها بذلك، قائلًا لنفسه إن أيامه قد أصبحت بذلك مؤمّنة مضمونه، إنه لا يرى لحماقته، أنه كلما أوغل في التكديس كان يغوص في عجزٍ قاتل. ذلك أنه يتعوّد أن لا يعتمد إلا على نفسه، ويفقد إيمانه بالتعاون، وينسى في عزلته القوانين التي تحكم الإنسانية حقًّا، وينتهي إلى أن يرتعد كل يوم خوفًا على ماله الذي أصبح حرمانه يحرمه من كل شيء. لقد غاب عن البشر تمامًا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق في الحياة بالعزلة، وإنما باتحاد الجهود وتناسق الأعمال الفردية”.
كأن دوستويفسكي يريد أن نبلغ معه وهو يحوّل آخر رواياته (أنهاها قبل رحيله بعامٍ واحد)، إلى ما يشبه الوصية، أو حتى الوصايا بالجمع، وليس وصية واحدة، أن نبلغ معه درجة ازدراء العزلة، والنظر إليها بوصفها جحيمًا من سوء الفهم، ولؤم المقاصد، وعماء التواصل، وبؤس الطالع.
إنها، أي العزلة في وجدان الروائي المضطرب، وفي غرف وعيه المستتر، خرابُ بُنيان، لا منشأُ عِمران.
هي دعوة لأن نخرج للحقول، نغتسل بكروم القرى، وقمح البلاد، ونصعد حتى أعالي مجد عمّاتنا النخلات، ونفتّش، من دون وَجَلٍ ولا (فوبيا) مرتجفة، عن كرمل حيفا داخل ثنايا الروح، فلعل الحياة بكامل مشمشها، الحياة المشرقة مثل الصباح، الجميلة كالقمر، الطاهرة كالشمس، المرهبة كجيشٍ بألوية، لعلها في انتظارنا، هناك خلف بحر بيروت، وجبل جلعاد، وأسواق حلب العائدة من الرماد.
ضفة ثالثة